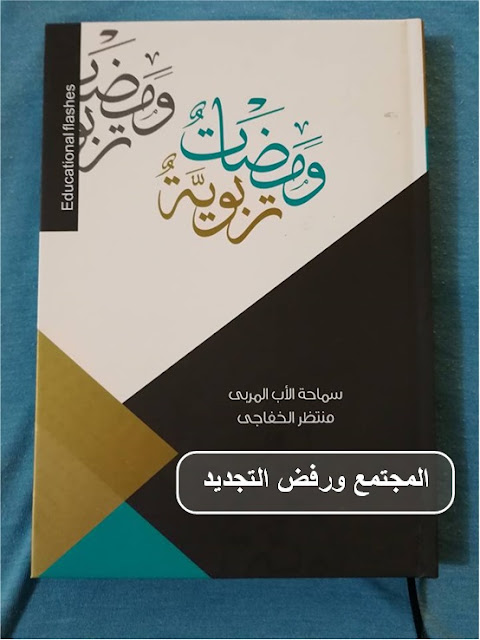 |
| المجتمع ورفض التجديد |
المجتمع ورفض التجديد
من خلال استقراء
التأريخ في ماضيه وحاضره وربما في مستقبله نرى تأصّل ظاهرة معاداة التجديد، فنبصر
السمة الغالبة على أكثر المجتمعات والأغلب في المجتمع الواحد أنه يرفض بل ويحارب
كل من يحاول أن يأتي بشيء جديد على المستوى الفكري أو التطبيقي في شتى المجالات،
مع غض النظر عن كون ما يأتي به المجدد ايجابياً أو سلبياً، فترى أفكاره ونظرياته
تجابه بردود فعل عنيفة تستهدف القضاء عليها، ثم بعد مضي مدة من الزمن نرى نفس
المجتمع الذي حارب هذه الأفكار يمجد ويعظم هذه الأفكار وصاحبها ويدعو لتطبيقها،
وغالبا ما يكون هذا التمجيد بعد خسران المجتمع لذلك المجدد، وهذا ما رأيناه بدءاً
بأصحاب الرسالات وانتهاءً إلى المفكرين والمصلحين وما زلنا نعيشه. بل حتى على
مستوى الاحتياجات المادية ترى المجتمع ينبذ الصناعات والمبتكرات الجديدة ويتمسك
بما هو قديم.
فهل أن هذه
الحالة تكوينية في الإنسان؟ وهل هي صحية وحسنة
في المجتمع؟ وهل من احتمال أن يتجاوز الإنسان هذه الحالة ويكسب الوقت الذي يضيعه
في رفض التجديد؟.
حسب فهمي والله
العالم، أن هذه الحالة ليست تكوينية وإلا لرفضها كل المجتمع وما قبلتها فئة دون
فئة. وليست هي حالة صحية تلك التي تؤدي الى ظلم المجددين. إنما هناك عدة أسباب
ولّدت هذه الحالة.
وأهم هذه
الأسباب:
أولاً: الاعتياد النفسي. فإن النفس إن اعتادت على شيء صعب إقلاعها عنه إلى
شيء جديد؛ لأن الاعتياد غالبا ما يولد تعلق بالشيء يصعب مع هذه العُلقة التجرد
والتخلي عن ذلك الشيء.
ثانياً: الاستقرار. فإن من طبع الإنسان حب الاستقرار والبقاء على حالة واحدة.
فهو عدو لكل ما يزلزل هذا الاستقرار. فَطروء الأفكار الجديدة يوجب على الإنسان هدم
استقراره والكون في حالة اللااستقرار للانتقال من حالة إلى أخرى، ثم يبدأ
الاستقرار على الحالة الجديدة.
ثالثاً: التكاسل عن فهم ما هو جديد. فيدفع هذا التكاسل الإنسان إلى الإدبار
عن كل ما يتطلب منه جهداً سواء في فهمه أو تطبيقه.
رابعاً: الخوف. فإن الفرد وبالتالي المجتمع يخشى كل ما هو جديد، وهذه الخشية
منبعها احتمال فقدان القديم وعدم ارتقاء الجديد إلى مستوى فائدة القديم. فيخشى من
كون الجديد أدنى مرتبة من القديم وأقل جدوى. فيكون معتقده (قديم تعرفه خير من جديد
تجهله).
خامساً: النظر الخاطئ إلى أن كل جديد هو هادم ومقوض وليس مشيد وبانٍ. فيعتبر
المجتمع أن الآتي يُهدد ما هو عليه من الأسس القديمة، فيحاول إبعاد هذا الجديد بأي
شكل ممكن.
هذه ربما
الأسباب الأبرز لنبذ التجديد والمجددين ومعاداتهم.
وهذا الرفض
بدوره يخلف أضراراً فادحة بالمجتمع - وطبعاً كلامنا عن التجديد الايجابي والإصلاحي-.
الأضرار
المحتملة
إن أبرز الأضرار
المترتبة على رفض التجديد هي:
أولاً: تخلف المجتمع عن مستوى الرقي المرسوم له. فإن مجيء الشخص المجدد أو
الأفكار التجديدية لا يمكن أن تأتي في غير وقتها، إنما جاءت في وقتها حسب نظام
الترقي المتسلسل، فعدم اعتناء المجتمع بالمجدد أو الأفكار والنظريات التجديدية
يؤدي إلى تخلف المجتمع وتأخره عن بلوغ ما يراد منه.
ثانياً: حرمان العقل من أفكار ونظريات وتصورات توسع بدورها المدارك العقلية
وتنقل العقل إلى مستوى جديد ربما تتغير فيه مقاييسه وتُعدل زاوية النظر لديه.
ثالثاً: إن المجتمع الذي يعادي ويضيق على قواده وأعني المجددين، سيكون
متأخراً رتبة عن المجتمعات الأخرى، وطبيعة الترتب المجتمعي أن المجتمع المتأخر
يكون مَقوداً للمجتمع المتقدم وليس في مصاف المجتمعات القائدة.
رابعاً: أن المجتمع الذي اعتاد محاربة المجددين سوف يثبّط همة كل من يروم
التجديد، فتموت الأفكار في صدور أصحابها ويحرم المجتمع من فوائد هذه الأفكار والنظريات.
خامساً: إن الأفكار والقيم والنظم والنظريات القديمة التي يتمسك بها
المجتمع ليست خالدة ولا ينبغي لها ذلك بحسب نظام (لِكُلِّ
أُمَّةٍ أَجَلٌ). فإن الأفكار والأنظمة والنظريات لها أجل محتوم وعمراً لا
تتعداه، فتمر بفترة النشأة ثم البلوغ ثم الكهولة ثم الموت. فعدم قبول الأفكار
الجديدة مع موت الأفكار والمعتقدات القديمة ولو تدريجاً، يجعل المجتمع مواتاً
لتمسكه بميت أو قلّ لأنه يُقاد من قِبل ميت.
هذه ربما أهم
وأكبر الأضرار التي تصيب الأفراد والمجتمعات الرافضة للتجديد والنابذة لأهله.
لكن الإنسان بما
وهبه مبدعه عز اسمه من القدرة اللامحدودة يستطيع تجنب هذه الأخطار عبر إيجاد
العلاج الناجع لهذا المرض.
العلاج المقترح
الذي نراه
مناسباً لسد هذا النقص وتلافي أضراره:
أولاً: التخلي عن نظرة التقديس لكل قديم إلا ما كان مقدساً فعلاً، فإن رفع
الأفكار والنظريات القديمة إلى مرتبة القداسة يجعل لها حصانة مانعة عن كل تغيير.
فيلزم أن تكون معاملة الأفكار القديمة بمستوى الأفكار الجديدة إن لم تكن بمستوى
أدنى.
ثانياً: تقييم الفكرة أو النظرية أو المعتقد بقيمة ما يعطيه، وعلى قيمة عطاءه
يكون بقاؤه، وليس ثمة فكرة لا نهائية العطاء إلا ما كانت صادرة ممن هو لا نهائي
وقاصد بقاءَها إلى ما لا نهاية.
ثالثاً: دراسة الأفكار والنظريات الجديدة وحتى شخصياتها دراسة منصفة معتدلة
قبل الحكم عليها.
رابعاً: التخلي أو قلّ تسقيط النظرة العملية المبتنية على أن كل جديد هو
هدّام وليس بنّاء، بل يُعامل كل جديد على أنه ربما يكون تمام وكمال لما سبق وإن
اقتضى إزالة بعض الأسس التي أثبتت عدم وملاءمتها للمرحلة.
خامساً: اليقين بقاعدة البقاء وأعني المسطورة في قوله: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) [سورة الرعد اية 17] وهي قاعدة عمّت كل القوانين والأنظمة الكونية والتشريعية السماوية
والأرضية. فإن الاعتقاد العملي بهذه القاعدة يزيل مخاوفنا من زوال ما هو مفيد
ويذيب الخشية من التجديد. فإن كل فكرة أو معتقد أو نظرية خاضعة لقانون تمحيص
الأفكار، فإن كانت متلائمة وأسس النظام العام بقية وثبتت وإلا زالت، ويُقرَر عمرها
على أساس عطاءها للنظام.
سادساً: المقارنة العقلية القائمة على أسس قطعية بين الأفكار والنظريات
القديمة وبين الجديدة، فإن حوت الأفكار الجديدة على عطاء أوسع وأشمل للمجتمع أو
الفرد من الأفكار القديمة قُدّمت وأُخرت القديمة.
وحسب اعتقادي أن
المسير على هذه الخطوات سيجنب لو بمقدار قليل الفرد والمجتمع ويبعده عن الوقوع
بالظلم الأكبر وهو ظلم المجدد وظلم النظام الالهي وظلم المجتمع بحرمانه من
استحقاقه.
وله الحمد


تعليقات: 0
إرسال تعليق